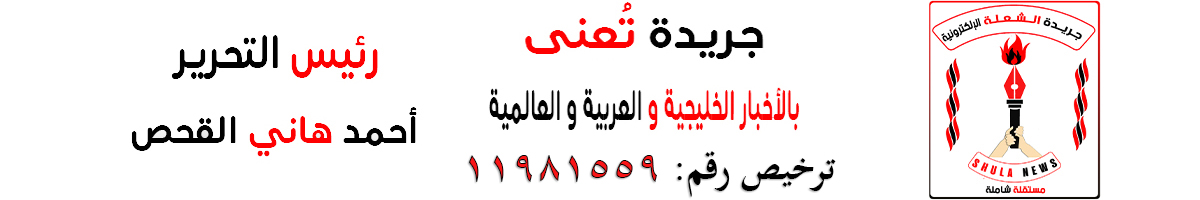«طائر الحرية .. الحبيب الجنحاني» باقة ورد على قلب نابض وفكر فاعل

أصدرت دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع كتاب «طائر الحرية ـ الحبيب الجنحاني» وذلك بمناسبة تكريم المفكر التونسي د. الحبيب الجنحاني في يوم الوفاء الذي تكرم خلاله الدار مجموعة من المبدعين العرب الأحياء.. احتوى الكتاب على رصد محقق ومفصل لمسيرة الجنحاني العلمية والفكرية والمهنية والاجتماعية وعطاءاته في هذه المجالات من خلال تتبع سيرة حياته وإجراء لقاء معه، كما شارك أصدقاؤه في كتابات عنه.
قدمت للكتاب د.سعاد الصباح في كلمات معبرة تحت عنوان «الجنحاني على أجنحة الحرية» وقالت فيها:تحط طيور الوفاء هذه المرة في أرض غالية من الوطن العربي.. أرض لها في النفس حديث ذو شجون.
«يوم الوفاء» تلك المبادرة التي اطلقتها لتكون باقة ورد لا توضع على ضريح.. بل على قلب حي نابض وفكر فاعل، وقد بحثنا طويلا في شخصية هذا العام الجديرة بالتكريم والاحتفاء.. فكانت جهتنا تونس الخضراء.
واضافت: ان للفكر فرسانه، وان للكلمات مهندسيها، وما اجمل ان يمتد العطاء بالانسان امتداد انفاسه، ليقدم للانسانية اولا، ولأبناء امته ثانيا ما ارتشفته نفسه من رحيق العلم وثمار المعرفة وجنى الايام.
وأمد بصري جهة الغرب من القلب العربي النابض، لأرى قامة تملأ الافق وتشغل الفكر وتشتغل به، ارى اسما يحمل مسماه، فيطير بأجنحة الفكر ويسمو على بساط العلم.
وقالت: د.الحبيب الجنحاني.. ذلك العلم الذي جمعني معه عمل طويل في مجال حقوق الانسان، ومنتدى الفكر العربي، ومنتديات سياسية وقومية، فكان نعم الزميل المخلص والمحب لعمله وللانسان، وانني اذ اكتب مقدمة كتاب تكريمي عن رجل بهذا العطاء، يحتوي شهادات اصدقائه ومحبيه فيه، اجدني ممسكة بالقلم من حافته كي لا يفيض الكلام ولا يندلق الحبر، فالمقام لا يتسع.. لذلك اترك ما تبقى لشهادات اصدقائه ومحبيه ومريديه، واذا كان المرء يعرف بأقرانه وبأصحابه، فهل يسأل سائل عن الحبيب الجنحاني وهو الذي نهل من افكار الاقدمين والمحدثين، وأعاد صياغة بعضها بما يتسق والعصر الذي يعيش فيه، او الظرف الذي يحيط؟!وتابعت: لاشك ان التواصل مع الحبيب الجنحاني في هذا التكريم يحقق صلة الرحم المعلقة منذ زمن بين الكلمتين العربيتين المشرقية والمغربية، ومن مزايا هذا التواصل أن نرى أقلاما مخلصة تنبري لتقريظ مستحق لهذا المفكر العلم، مثل د.فوزية بلحاج المزي، واحمد الحمروني، وصلاح الدين الجورشي، وعزيز بن ابي المعز، والمنصف ثوجة.. وغيرهم.
وإن المبررات التي تدفع المرء الى تكريم شخصية كالجنحاني اكثر من ان تحويها اسطر قليلة، فمسيرة هذا الرجل الممتدة عبر عشرات السنين تشهد له، وتسجل انه لم يكن رقما زائدا في تاريخ بلده، انما هو ذلك الرقم الصعب الذي ناصر الانسان في قضيته الجوهرية، بأنه انسان، ولاحق العلم منذ نعومة اظفاره في بلاده تونس ثم في تغربه الأوروبي.
وختمت، وها نحن الآن نقول له شكرا على طريقة زملاء سلاح الكلمة، ونتمنى له دوام العافية وسلامة البال.. لينضم إلى الكوكبة التي قمنا بتكريمهم وهم على قيد الحياة.
وعقب المقدمة تناول د.الحبيب الجنحاني سيرته الذاتية قائلا: أتذكر الآن وأنا اشرع في كتابة هذا التقديم جملة الفيلسوف الانجليزي النمساوي الاصل كارل بوبر: «ماذا اترك وماذا ابقي؟ هذه هي المسألة».
إنها حيرة ترتبط بالموضوعية وترتبط قبل ذلك بتحديد الهدف، ماذا اروي، وماذا احذف مما يزدحم في الذاكرة من أحداث؟وأضاف الجنحاني: لا مناص إذن من الغربلة والانتقاء، وبعد التردد اخترت التلميح الى الأحداث التي تسهم في توعية القارئ العربي بالقيم التالية:- الثورة ضد جميع مظاهر الظلم السياسي والاجتماعي.
– التمسك بمبادئ العقلانية والحداثة، وأعني الحداثة المطلة علينا من عباءة عصر الأنوار.
– الإيمان بالحرية، والنضال في سبيلها حتى آخر رمق.
وقال: قد يبادر البعض قائلا: انه حلم جديد يشبه الأحلام القديمة المتهاوية، ماذا تستطيع النصوص ان تؤثر في تحقيق هذه القيم؟ فالنصوص هي التي تنير السبل وتبعث التفاؤل وبخاصة عندما ينتشر الظلام، وتزحف الخفافيش من جحورها، اذ ان النصوص الهادفة ليست منعزلة عن بيئة أصحابها وعن حيرتهم المؤرقة.
وأكد أن هذا النص هو سرد لذكريات معينة، وليس كتاب تاريخ، فمن الطبيعي ان تتداخل الأحداث لتتوالى أحيانا، وتنقطع أحيانا اخرى.
وكان من الممكن ان يكون هذا النص اكثر تفصيلا وأشمل في موضوعاته، ولكنه من النصوص التي تكتب في ظرفية تاريخية معينة محاولة الكشف عن شيء ما.
وأضاف الجنحاني أن التكفير عن الذنوب لا يحتمل التأجيل، انه تكفير عن ذنب تأييد نظم سلطوية معادية للحريات العامة، انه إسهام متواضع في إماطة اللثام عن الوجه الحقيقي لجلاوزة القرن العشرين، ويندرج ضمن مسعى التكفير وضع صاحب النص تجربته النضالية في المجالين السياسي والنقابي تحت تصرف الأجيال الجديدة المناضلة في سبيل تنبيت قيم المواطنة والحريات العامة في التربية العربية.
وجاء الكتاب في 295 صفحة، أشار الجنحاني خلال جزء منها الى سيرته الذاتية متناولا مرحلة النشأة بدءا من التحاقه بالمرحلة الابتدائية للتعليم في أربعينيات القرن الماضي وذلك في حقبة الإدارة الاستعمارية الفرنسية التي سعت الى تنشئة جيل من المتعلمين التونسيين المؤيد لها، وقد فشلت في سعيها كما اثبت ذلك تاريخ الحركة الوطنية التونسية، فلم يكن من مصلحة النظام الاستعماري ان تتحول الزيتونة الى معقل من معاقل الفكر الجديد.
وعاش الجنحاني المرحلة الأخيرة من مراحل نضال الزيتونيين في سبيل تحديث نظامهم التربوي وامتزجت هذه المرحلة بالمعركة الحاسمة في تاريخ الحركة الوطنية من اجل الحرية والاستقلال 1952-1956 ومن هنا التحم النضال الطلابي بالنضال الوطني.
وأكد الجنحاني ان الظروف التاريخية التي عرفتها البلاد في مطلع الأربعينيات حرمته من الانتساب الى مدارس النظام التربوي الحديث، ولكنه يحمد الله على ذلك لأن انتسابه الى النظام الزيتوني جعل شعلة الثورة تدب في عروقه منذ بداياته، وبدأت مساهماته السياسية مبكرا، حيث شارك في مظاهرات صوت الطالب ثم انضم الى مظاهرات اليسار التونسي.
ويقول الجنحاني: الشعور بالتحدي جعلني ابحث عن منافذ الهجرة الى الشمال لأنهل من منابع الفكر الحديث وأسد ثغرات التعليم الزيتوني.
وأكد أنه لو لم يلغ التعليم الزيتوني لاستمرت الثنائية المقيتة داخل صفوف النخبة التونسية، وإذا انصهرت هذه الثنائية، وتوارى خطرها في مرحلة التحرر الوطني، فقد كان متوقعا ان تطل برأسها غداة الاستقلال، ويستمر «جهاز البلاد الثقافي مشطورا دائما الى شطرين» كما وصف الشيخ الفاضل بن عاشور الوضع الثقافي قبل الاستقلال.
وقال الجنحاني: ان الغاء التعليم الزيتوني لا يقل شأنا عن قرار تحرير المرأة، وسياسة نشر التعليم.
الهجرة الأولى
بدأ الفتى يعمل موظفا صغيرا في حقل المكتبات، ولم يعرف من رشحه لوزير التربية في حكومة الاستقلال الراحل الامين الشابي، شقيق الشاعرالشهير «ابي القاسم الشابي»، فأرسله في بعثة تدريبية الى المكتبة الوطنية، وادارة الوثائق العامة بباريس، فركب السفينة في اتجاه مدينة مرسيليا، وهو نفس الطريق الذي عبره الطلبة التونسيون للدراسة في فرنسا.
كان الانبهار كبيرا والصدمة الحضارية عنيفة، اذ انتقل الفتى بين عشية وضحاها من قلب مدينة عربية اسلامية بأسواقها التي هي امتداد لاسواق المدينة العربية في العصرالوسيط، وبمؤسساتها التعليمة الى مدينة النور باريس.
ولم يذهب به الانزلاق بعيدا، فلم يهمل امرين اساسيين: التردد على مناهل المعرفة، والعمل السياسي، وقد هيمنت الثورة الجزائرية في منتصف الخمسينيات على المنابر السياسية الباريسية بشتى تياراتها.
واكتشف الفتى الزيتوني في باريس انه كان ثائرا تحت العمامة لما انخرط في حركة النضال الطلابي في سن مبكرة، فشارك في المظاهرات من اجل تحديث التعليم الزيتوني، وضد النظام الاستعماري الفرنسي، اذ وجد نفسه شغوفا بحركات اليسار الفرنسي دون ان يدرك يومها الفروق بينها، وأن يعرف موقفها من حركات التحرر الوطني، وبخاصة موقفها من الثورة الجزائرية، ومن القضية الفلسطينية.
الهجرة الثانية
الهجرة الثانية لم تكن نحو الشمال، بل كانت نحو المشرق العربي، وبالتحديد نحو مصر، وقد جاءت مرتبطة بالأولى، فبعد الاطلاع على مناهج فن المكتبات في الغرب تقرر ارسال الفتى في بعثة تدريبية الى كل من دار الكتب، ومعهد المخطوطات بالجامعة العربية، وكان المشرف على ادارتها الثقافية يومئذ طه حسين، وقد فوت صغر السن على الفتى السعي الى مقابلته، والتحدث اليه.
الهجرة الثالثة
تكمن خطورة هذه الهجرة في التعرف الى عالم جديد يختلف تمام الاختلاف عن عالمي الهجرتين الاولى والثانية، يختلف في مبادئ الايديولوجية الرسمية التي يستند اليها النظام السياسي القائم، ويختلف كذلك في النمط المعيشي اليومي، اذ انه استطاع ان يربي اجيالا جديدة لها نظرة اخرى الى الحياة وإلى العالم.
عاش الفتى نتيجة هذه الهجرة ثمانية اعوام خلف ما سمي يومئذ بالستار الحديدي (خريف 1957 – ربيع 1965) وتنقل بين واجهتي النظامين: الاشتراكي والرأسمالي، فمن المعروف ان المعسكر الشرقي جعل من برلين الشرقية واجهة لمزايا النظام الاشتراكي: ضمان الشغل، العناية بالثقافة والفنون، العناية بالشباب، تمكين ابناء العمال والفلاحين من دخول الجامعة، العلاج المجاني، وغيرها من مكاسب النظام، وجعل النظام الرأسمالي من برلين الغربية واجهة لمزايا النظام الرأسمالي، وخصص ميزانية ضخمة لتزيين هذه الواجهة.
ان الهجرة قد تركت اثرا بعيد المدى في التحول السياسي والفكري للفتى، ولكن هذا التحول تزامن مع الجانب المعرفي في حياته، فهو الذي مكنه من اتقان اللغة الالمانية، والدراسة في مدينة جامعية عريقة اشتهرت بتقاليد الطباعة العربية، ونشر عدد كبير من مصادر التراث العربي الاسلامي، كما عرفت مدينة لايبزيغ برسوخ تقاليدها الاستشراقية، وصادف ان يكون من العرب الاوائل الذين درسوا في معهدها الاستشراقي، وتعلم على يديه العربية عدد من المستشرقين الجدد الذين رعاهم النظام ليؤسس مدرسة استشراقية ماركسية.
ومكنت الهجرة الثالثة الفتى من التعرف عن قرب على مدى احتدام الصراع بين المعسكرين الشرقي والغربي، عاش ذلك في تنقله بين شطري برلين ولمسه كذلك في محاولة منظمات طلابية غربية التأثير عبر اساليب مختلفة في اقناع الطلبة العرب والافارقة بمغادرة جامعات اوروبا الشرقية، والالتحاق بالجامعات الغربية، والتنديد بالنظام السياسية القائمة فيها، وربما الافادة منهم في الحصول على معلومات، اذ إن الطلبة الأجانب لهم وحدهم حرية السفر بين الشرق والغرب، ولعل هذا ما يفسر وضعهم تحت مراقبة شديدة في البلدان التي يدرسون بها.
العودة إلى أرض الوطن
ويقول الجنحاني: بعد أن قضيت أكثر من عشر سنوات في المجتمعين «الاشتراكي» و«الرأسمالي» عرفت أثناءها نقاط القوة والضعف فيهما، عدت الى أرض الوطن لأنتسب الى الجامعة التونسية، وانضم الى جيل بُناتها، وهو الجيل الذي سعى بكل قواه لأن تكون قاطرة التقدم، وان يحمل المتخرجون فيها رسالة التوعية، وان يكونوا من رواد المبشرين بالفكر الحداثي باعتباره الخطوة الأولى في طريق أي تجربة ديموقراطية، وآمن بضرورة توحيد الصفوف للتصدي ضد محاولات التوظيف السياسي، فكان المبدأ الأساسي هو الدفاع عن القيم الجامعية رغم تباين المشارب السياسية والفكرية.
ويضيف الجنحاني: قد يتساءل المرء عن الهدف من التركيز على القضايا الفكرية؟أولا: للإسهام المتواضع في نشر قيم الحرية والحداثة.
ثانيا: لأن ملامح عصر العولمة قد أوضحت ان الاستبدادية العربية أفل نجمها، وأشرفت على السقوط لتترك المجال إلى الفكر العقلاني.
ثالثا: ان أي تغيير جديد سيؤول إلى الفشل ان لم يحمل رواده مشعل المعالجة العقلانية للقضايا الجديدة، لذا آمنت منذ البداية بضرورة الكتابة الصحافية فكتبت في صحف تونسية واسعة الانتشار مثل «العمل» و«الصباح» و«الشروق» وكتبت خارج تونس في «الحياة» و«الزمان» و«الزمان الجديد»، وساهمت بانتظام في ركن القضايا الفكرية بمجلة «العربي» الكويتية، كما أسهمت في موقع «الأوان».
وشاركت في الوقت نفسه في مؤسسات المجتمع المدني تونسيا وعربيا ودوليا.
وبعد ان سرد الجنحاني سيرته الذاتية جاءت آراء عدد من الكتاب في تلك المسيرة ليلقوا المزيد من الأضواء على حياته الفكرية.
فتناول الكاتب التونسي محمد أنور الهجرات الأربع تحت عنوان «الحبيب الجنحاني.. سيرة ثائر تحت العمامة».
ثم يأتي الكاتب الأردني د. زهير توفيق معنونا ذكرياته بعنوان «الحبيب الجنحاني المفكر النقدي والمثقف الحر»، مؤكدا ان الجنحاني لم تأسره الايديولوجيات الجاهزة رغم جاذبيتها وظل واقفا على مسافة كافية منها للتعرف عليها دون انخراط بها.
اما الكاتب التونسي صلاح الدين الجورشي فأكد ان الجنحاني من الأسماء التونسية التي فرضت نفسها منذ وقت مبكر، بل هو أحد ممثلي النخبة التونسية في الحراك الفكري والايديولوجي.
بدوره، اشار الكاتب التونسي محمد عيسى المؤدب الى ان الجنحاني احد رواد الثقافة التونسية الحديثة لانه اسهم في حركة التحرر الوطني ثم عرف مناضلا سياسيا ونقابيا وتواترت كتاباته التاريخية والفكرية ليمثل احد رواد الفكر التنويري.
وقال الكاتب والباحث التونسي احمد الحمروني ان الجنحاني يختزل في حياته العلمية والعملية نضال جيله في تونس والوطن العربي، فقد دافع عن الهوية دون مخاصمة الحداثة وناهض العولمة دون التقوقع في الاصالة.
واشار الكاتب والمؤرخ عبدالجليل التميمي الى دور الجنحاني في خدمة الاشعاع العلمي العربي، مؤكدا انه عرف عنه دفاعه المستميت عن الثوابت والمبادئ الحضارية للامة العربية والاسلامية، ولم يهادن مطلقا من سعى الى تقزيمها والتقليل من شأنها.
وتحت عنوان «همس الحرية في زمن القمع» قالت الكاتبة التونسية د.فوزية بالحاج المري، ان الجنحاني استباح الممنوعات الاساسية والمحاذير التي تتوجس منها الانظمة الاستبدادية.
اما د. حمادي حمود فيؤكد ان الجنحاني احد المؤرخين المعدودين المتخصصين في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للمغرب لاسلامي والانماط الاقتصادية السائدة في بلاد الاسلام.
بدوره، قال الكاتب التونسي المنجي الشعار ان هجرات الجنحاني المتعددة لم تمنعه من العودة الى مدينة النشأة الاولى للمساهمة في العمل الاجتماعي الانساني.
الى ذلك، قال الكاتب والباحث عيسى البكوش ان المثقف العضوي هو من يحمل القلم بيد والمعول بالاخرى، وذلك الوصف ينطبق على الاكاديمي والاديب الحبيب الجنحاني.
وتحت عنوان «الجنحاني.. بين ومسألة الماضي وسؤالي الحاضر والمستقبل»، ويقول الباحث في تاريخ العصر الوسيط المنصف ثوجة ان الجنحاني اختار عدم البقاء في الابراج العاجية للباحث الاكاديمي والجامعي التقليدي ولم يكتف بشهادته على العصر بل اراد ان يكون فاعلا في تغيير المشهد السياسي.
الجنحاني والخلدونية
تجدر الإشارة إلى تأثر الفتى بالمصلح التونسي الشيخ الفاضل بن عاشور، فقد كان من رواد دروس الجمعية الخلدونية، وكانت حول زعماء الإصلاحية الإسلامية مثل الأفغاني وتلميذه محمد عبده، والطهطاوي وغيرهم.
كانت الخلدونية في أهدافها وبرامجها قريبة من «الصادقية» في مرحلتها الأولى قبل ان تصبح خاضعة للسلطة الفرنسية، وقد هدف المصلح خير الدين من النص المنظم للتعليم الزيتوني ان تتقلص الشقة بين المؤسستين.
ويقول الجنحاني: إنني أعتز اليوم بعد هذه الرحلة الطويلة ذات الروافد المتنوعة ان أكون منحدرا من سلالة هذه الفئة من الزيتونيين.